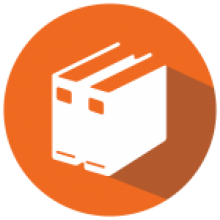- الرئيسية
- مديرية التراث
- نبذه عن المديرية
المزيدأولاً: نشأة المديرية تم تأسيس مديرية التراث في نهاية عام 2010 وذلك حرصاً من وزارة الثقافة على رعاية وصون التراث الثقافي غير المادي في المملكة الاردنية الهاشمية. «التراث الثقافي غير المادي » الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية...
- أهداف مديرية التراث
- اقسام المديرية
المزيدأقسام مديرية التراث: 1- قسم البرامج التراثية : من أبرز مهامه تنظيم وتنفيذ ومتابعة المشاريع والبرامج والأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي ضمن خطة المديرية والجهات ذات العلاقة، ومتابعة الاتفاقيات التي تعقدها المملكة مع المنظمات والهيئات الدولية لغايات تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن نطاقها. 2...
- الاصدارات المزيد
- التعليمات والاتفاقيات المزيد
- نبذه عن المديرية
المزيد
- المشاريع
- مشروع المكنز الوطني
المزيداختصاصات لجنة ذاكرة العالم الأردنية الاسم: Jordanian Memory of the World committee اللجنة الأردنية لذاكرة العالم الهيكل: تتألف لجنة ذاكرة العالم الأردنية من لجنة رفيعة المستوى و 4 لجان فرعية متخصصة في مختلف جوانب اللجنة. الوظيفة: ستضطلع لجنة ذاكرة العالم في الأردن بمسؤولية...
- المشروع الوطني لحصر التراث
المزيدنبذة عن المشروع يهدف هذا المشروع إلى حصر التراث الثقافي غير المادي في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتزامن. كما يهدف إلى إشراك المجتمع المحلي في الجرد، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، وتحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي المهدّدة بالانقراض، ورفع الوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي حتى...
- مشروع تفريغ و أرشفة أشرطة الكاسيت المسجلة في أواسط السبعينيات
المزيدمشروع إعادة تأهيل المادة الصوتية المسجّلة في السبعينيات من القرن الماضي. (الذاكرة المسجّلة في أشرطة الكاسيت التقليدية) للحفاظ على الموروث الأردني الثقافي، والكنز الذي قامت بتسجيله نخبة من الباحثين في التراث في أواسط السبعينيات، وفي مناطق مختلفة من المملكة، ارتأت مديرية التراث أن يصار إلى البحث عن...
- برنامج ذاكرة العالم
المزيداختصاصات لجنة ذاكرة العالم الأردنية الاسم: Jordanian Memory of the World committee اللجنة الأردنية لذاكرة العالم الهيكل: تتألف لجنة ذاكرة العالم الأردنية من لجنة رفيعة المستوى و 4 لجان فرعية متخصصة في مختلف جوانب اللجنة. الوظيفة: ستضطلع لجنة ذاكرة العالم في الأردن بمسؤولية...
- مشاريع مدن الثقافة
المزيد
المشاريع
تم تخصيص جزء من مخصصات مدن الثقافة والالوية في الاعوام السابقة لدعم مشاريع تراثية تُعنى في الحفاظ على الموروث الشعبي الاردني وتسويق المنتج التراثي ودعم الافراد والجمعيات والفرق التراثية. حيث قامت مديرية التراث بالتنسيب بدعم المشاريع التي تحقق روية ورسالة المديرية وتسلط الضوء على المنتج التراثي... - مهرجان التنوع الثقافي
المزيد
المشاريع
يأتي ضمن احتفالات العالم باليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي يصادف 16/5 من كل عام، ويهدف هذا المهرجان إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي الاردني وتعزيز الترابط بين كافة أفراد المجتمع الأردني وإبراز نسيج الحضارة الأردنية وجماليات التنوع الثقافي في الأردن والتعريف بالهوية الثقافية المتميزة لدى الأردن... - ترشيح العناصر على قوائم التراث الثقافي غير المادي
المزيد
المشاريع
بعد ان يتم حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي في المملكة وادراجها على قوائم الحصر لدى مديرية التراث، تقوم المديرية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بترشيح عناصر مختارة على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي. إن ترشيح عنصر واحد على قوائم التراث سواء كان ملف وطني أو مشترك يستغرق عامين ويتطلب تحضير... - العناصر الاردنية المدرجة على قوائم اليونسكو
المزيد
المشاريع
تم ترشيح ملف (العادات والتقاليد والممارسات المتعلقة برقصة السامر) في الاردن على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وستعلن نتائج الترشيح خلال شهر تشرين الثاني من العام 2018. ترشيح ملف النخلة والعادات والطقوس المرتبطة بها: تراثاً عربياً مشتركاً على القائمة التمثيلية للتراث...
- مشروع المكنز الوطني
المزيد
- المركز الإعلامي
- قواعد البيانات
- قاعدة بيانات المكنز الوطني
المزيد

- قوائم الحصر الوطني
المزيد

- قاعدة بيانات الحرفيين
المزيد
قاعدة بيانات الحرفيين
- قاعدة بيانات المكنز الوطني
المزيد

الصيدة التي علمت صاحبها النحت في الصخر إبراهيم السواعير
الصيدة التي علّمت صاحبها النحت في الصخر
عاد الراعي ولم يعد رفيقه
إبراهيم السواعير·
الزمان 1968
المكان الديسة/ إحدى أعمال القويرة في رم.
يتأهّب الشيخ جليّل الصيّاح، وسالم صيّاح الزوايدة للبحث عن غضيّان، حاثّينِ الخطى الثقيلة بالأمل الضائع في سراب صحراء لا انتهاء لها، يتحسسانِ كثبان رم، ويتحرقان ألمًا، وقد مرّ أسبوعٌ أو يزيد، ولم تلُح في الأفق بارقة أملٍ، أو شارةٌ تدلُّ عليه! ولكن، ما زال على الرمل متسعٌ للجديد، ولا بدّ أنّ وراء عصائب الطير، وراسيات رم ما يبعث في العروق دماء التفتيش عن الغائب!.. البعيد!.. وبين الظلّ والحرور، والأمل والقنوط، يقطع الشيخان مسافاتٍ ومسافاتٍ يرافقهما شابٌ لم يزد عن العشرين إلا قليلًا: كوته الهاجرةُ، وبانت ملامح الصحراء عليه، وخطّ عجاجها على وجهه أنه منذورٌ لها، منذ أن دبّ على رمالها عام 1945 ... ليعلو الصوت: غضيّان!.. غضيّان!... فيجيب الصدى: مات، وقد غالب الحيّة.. وتحمل زعافها، فتأرجحت آثار خطاه دون انتظامٍ، وحفرت أظفاره في الرمل آخر عهده بالدنيا، ليروي عذابات الأردنيين مع الصحراء، ومجاهدتهم لتعميرها، وحفظ تفاصيلها عن ظهر قلب.
اليوم، يعود ذلك الشاب، محمد سالم الصيّاح الزوايدة، بالذاكرة ما استطاع، ليروي لمخيّم وزارة الثقافة الذي أقيم في رم ما جعل منه نحّاتًا يسكب وحي الصحراء على أحجار تصطفّ بانتظام: منحوت الدّلة، ومنحوت الصقر، ومنحوت أول حفيدةٍ له،.. ومنحوت الصيدة!...

والصيدة بلغة أهل الديسة ليست سوى الحيّة (الأفعى)، وهي بلغة محمد الزوايدة، ليست سوى الحيّة الأولى، التي قضت على غضيّان، وتركته ضجيع الصحراء أسبوعًا كاملًا من الزمان... الصّيدة كانت ملهمة النحات، وقد رأى ما رأى، واختمر في ذهنه المتفتّح على الجانب الآخر من الصحراء ما اختمر...
وعقب محاولاتٍ مبشّرة، أوقدت لديه جذوة البوح بحزن الميّت، بات محمد الزوايدة متخصصًا في منحوت الحية، التي تثير الهلع في النفوس، بسوادها الفاحم، ومرآها المنساب، وما ذاك إلا لدقة صاحبها، وذائقته الجمالية، واحترافه بتفاصيل التفاصيل.
يقول الزوايدة: قتلنا في ذلك اليوم، لا ردّه الله، عشر صيداتٍ حاولت النيل من غضيّان الذي اتخذنا له قبرًا في مكان مصرعه، لصعوبة نقله إلى مضارب القبيلة، التي ينطبق عليها، تلك الأيام قول: (الجميع: آخي، وابن آخي!...).. ومع أنّ ملهمتي الأولى، ظلّت تدور في ذهني، إلا أنني لاحقت الغزلان، وأسراب القطا، وجالست الشيوخ وأخذت عنهم، وبعد أن قطعت في الصيد شوطًا بعيدًا، عدلت عنه لحميميّةٍ بيني وبين الطرائد من النعام، والحجل، والشناّر، .. ثمّ يضيف: ومع أنني صقّار( أروّض الصقور، وأجعلها تألف المكان والإنسان)، إلا أنني لم أنسَ مهنتي الأساسية: تعمير البيوت، وهي التي تمرّستُ بها فن النحت، لفنّيات القياس، وجمالية المبنى، وهندسية البناء. ومن محاسن الصدف أن يشتغل الزوايدة مراقبًا لموارد الطبيعة ومكتسبات الصحراء، فيزيده التجوال هيامًا بالمكان، ثمّ يشتغل مراقب أبنيةٍ في القرية الناشئة، ... ثمّ هو اليوم، يتفرّغ للنحت، وليس إلا له، بعد أن تقاعد، ...
عن سيرته وتطورها مع هذا الفن، يقول: أظلّ أنتخب الحجر الطبشوريّ النادر انتخابًا من مكامنه في قيعان الأودية، وأحبّذه على غيره لمرونته، وقابليته للنقش، خصوصًا ما كان حسّاسًا في الوجه، كالأنف، والعينين،... وفيما يتعلق بالألوان، فإنّ منشأها الصخر الرمليّ المتنوع بها، وقد أمزج بينها حيثما كان ذلك ملحًّا بعد سحنها وتشريبها الحجر عاشق الامتصاص، بسنتيمتر واحدٍ أو اثنين!.

ومن المفارقات، أنّ الزوايدة يحاول أن يبتكر، ولكنه من منظورٍ آخر، لا يميل إلى النحت التضليلي، على حدّ رأيه، وهو النحت الذي يتوهم قارئه بمعان تتعدد، وإشاراتٍ تدلّ، قائلًا: أجد في حقيقة المنحوت سببًا في الاستمرار فيه!... وهنا فإن الزوايدة ينضمّ إلى المدرسة الواقعية في النحت، بالرغم من عضّه النواجذ على عدم تعلمه النحت في مدرسةٍ، أو جامعة، وما ذاك- والقول له - إلا لأنه يؤمن بأنّ الموهبة يستلزم رقيّها التعرف على المدارس المتباينة في هذا المجال.
يجد الزوايدة حافزًا قويًا، بالرغم من حقيقة التجسيم ووضوحه، مشيرًا إلى المتعة التي تلازمه في التفنن بمنحوت الصقر- مثالًا لا حصرًا- في الذيل، والريش، والمخالب، و... وما شابه، ولا يحتاج إلى كتالوج قبل المباشرة بالنحت، وممارسة طقوس التحضير له، بل إنّ دليله الأول والأخير مخّهُ، وما يرسخ في ذاكرته من صور المحيط. ويخالف الزوايدة كثيرًا من أبناء المهنة، قائلًا: البتراء، وجبال رم، بما تكتنفه من صور ليست غير موحياتٍ ثانويّة، تستمد من الطبيعة بمفهومها العام، وتنوعها الثريّ، ذاكرًا أنّه حاول أن يورّث أبناءه المهنة، وقد تخصصوا في مجالاتٍ بعيدةٍ حينًا، وذات صلةٍ حينًا آخر، خاصًّا ابنته التي درست الإنجليزية، واستهواها الرسم، بمساعدتها له، وقربها من إبداعاته.
الزوايدة الذي يلاعب ربابته بالشروقي والهجيني، وينقلها على أيّ لونٍ يشاء، لم يبخل على فنانينا القاصدين تصوير أعمالهم في رم، فشارك شاعرًا للقبيلة، ومدّ القائمين على الأعمال كثيرًا من عادات البادية، وواقعها، ومخالفًا كثيرًا مما حفظته الذاكرة البعيدة عن الصحراء: قلبًا وقالبًا.
الزوايدة شارك في قصر الثقافة بعمان، العام الفائت بخمس منحوتاتٍ، ودار على المدارس لتسويق المهنة، وهو رئيس فرقة الفنون الشعبية في الديسة، ويحترف، حتى النسيج، وهو على درايةٍ واسعة بتربية النحل، وأنواع العسل، ويطمح لتسويق المنتج عربيًا، والتعريف بالبيئة الأردنية، ومكوّناتها الغنيّة، ويعترف أن البعد عن العاصمة، ربما يكون له دورٌ في ضيق انتشار أعماله، وهو يؤمن أنّ وزارة الثقافة( راعية المخيّم)، لا تتوانى في التعريف بمبدعي الأطراف( والأطراف، حسب الزوايدة، هي البعيدة عن حراك العاصمة في كلّ شيء)، شاكرًا لها اهتمامها بجسد الثقافة الواحد، الذي كلما اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
الزوايدة، الذي وقف عند الثالث الإعدادي، العام 1965، في مدرسة القويرة الثانوية، ما زال ينحتُ حيّاته، وصقوره على أحجاره الخاصة، المنتقاة، التي تشرى بثمنٍ بخس، ويتداولها زوار المنطقة تذكارًا، أو هدايا، أو لمجرد تزيين المضافات، و الديكوريشن الملحق بها،... لا تماثله إلا عاصفات الريح والرمال، التي نحتت أوابد رم، من قبل!