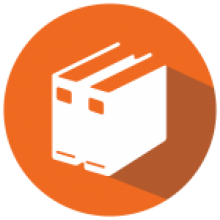- الرئيسية
- مديرية التراث
- نبذه عن المديرية
المزيدأولاً: نشأة المديرية تم تأسيس مديرية التراث في نهاية عام 2010 وذلك حرصاً من وزارة الثقافة على رعاية وصون التراث الثقافي غير المادي في المملكة الاردنية الهاشمية. «التراث الثقافي غير المادي » الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية...
- أهداف مديرية التراث
- اقسام المديرية
المزيدأقسام مديرية التراث: 1- قسم البرامج التراثية : من أبرز مهامه تنظيم وتنفيذ ومتابعة المشاريع والبرامج والأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي ضمن خطة المديرية والجهات ذات العلاقة، ومتابعة الاتفاقيات التي تعقدها المملكة مع المنظمات والهيئات الدولية لغايات تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن نطاقها. 2...
- الاصدارات المزيد
- التعليمات والاتفاقيات المزيد
- نبذه عن المديرية
المزيد
- المشاريع
- مشروع المكنز الوطني
المزيداختصاصات لجنة ذاكرة العالم الأردنية الاسم: Jordanian Memory of the World committee اللجنة الأردنية لذاكرة العالم الهيكل: تتألف لجنة ذاكرة العالم الأردنية من لجنة رفيعة المستوى و 4 لجان فرعية متخصصة في مختلف جوانب اللجنة. الوظيفة: ستضطلع لجنة ذاكرة العالم في الأردن بمسؤولية...
- المشروع الوطني لحصر التراث
المزيدنبذة عن المشروع يهدف هذا المشروع إلى حصر التراث الثقافي غير المادي في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتزامن. كما يهدف إلى إشراك المجتمع المحلي في الجرد، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، وتحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي المهدّدة بالانقراض، ورفع الوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي حتى...
- مشروع تفريغ و أرشفة أشرطة الكاسيت المسجلة في أواسط السبعينيات
المزيدمشروع إعادة تأهيل المادة الصوتية المسجّلة في السبعينيات من القرن الماضي. (الذاكرة المسجّلة في أشرطة الكاسيت التقليدية) للحفاظ على الموروث الأردني الثقافي، والكنز الذي قامت بتسجيله نخبة من الباحثين في التراث في أواسط السبعينيات، وفي مناطق مختلفة من المملكة، ارتأت مديرية التراث أن يصار إلى البحث عن...
- برنامج ذاكرة العالم
المزيداختصاصات لجنة ذاكرة العالم الأردنية الاسم: Jordanian Memory of the World committee اللجنة الأردنية لذاكرة العالم الهيكل: تتألف لجنة ذاكرة العالم الأردنية من لجنة رفيعة المستوى و 4 لجان فرعية متخصصة في مختلف جوانب اللجنة. الوظيفة: ستضطلع لجنة ذاكرة العالم في الأردن بمسؤولية...
- مشاريع مدن الثقافة
المزيد
المشاريع
تم تخصيص جزء من مخصصات مدن الثقافة والالوية في الاعوام السابقة لدعم مشاريع تراثية تُعنى في الحفاظ على الموروث الشعبي الاردني وتسويق المنتج التراثي ودعم الافراد والجمعيات والفرق التراثية. حيث قامت مديرية التراث بالتنسيب بدعم المشاريع التي تحقق روية ورسالة المديرية وتسلط الضوء على المنتج التراثي... - مهرجان التنوع الثقافي
المزيد
المشاريع
يأتي ضمن احتفالات العالم باليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي يصادف 16/5 من كل عام، ويهدف هذا المهرجان إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي الاردني وتعزيز الترابط بين كافة أفراد المجتمع الأردني وإبراز نسيج الحضارة الأردنية وجماليات التنوع الثقافي في الأردن والتعريف بالهوية الثقافية المتميزة لدى الأردن... - ترشيح العناصر على قوائم التراث الثقافي غير المادي
المزيد
المشاريع
بعد ان يتم حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي في المملكة وادراجها على قوائم الحصر لدى مديرية التراث، تقوم المديرية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بترشيح عناصر مختارة على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي. إن ترشيح عنصر واحد على قوائم التراث سواء كان ملف وطني أو مشترك يستغرق عامين ويتطلب تحضير... - العناصر الاردنية المدرجة على قوائم اليونسكو
المزيد
المشاريع
تم ترشيح ملف (العادات والتقاليد والممارسات المتعلقة برقصة السامر) في الاردن على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وستعلن نتائج الترشيح خلال شهر تشرين الثاني من العام 2018. ترشيح ملف النخلة والعادات والطقوس المرتبطة بها: تراثاً عربياً مشتركاً على القائمة التمثيلية للتراث...
- مشروع المكنز الوطني
المزيد
- المركز الإعلامي
- قواعد البيانات
- قاعدة بيانات المكنز الوطني
المزيد

- قوائم الحصر الوطني
المزيد

- قاعدة بيانات الحرفيين
المزيد
قاعدة بيانات الحرفيين
- قاعدة بيانات المكنز الوطني
المزيد

سيرة مكان حي جميل الصالح: المحطة د.عوني تخوج
حي جميل الصالح: المحطة
1955 – 1961
د.عوني تخوج
المكان..والناس
بعض الشعوب البدائيّة ذات التراث الأسطوريّ تعتقد أن لكلّ مكان روحه الخاصّة به، وأن المكان بخصائصه الذاتيّه يستجلب لصاحبه ذكرياته السارة والحزينة، وقد يزول المكان ويندثر لكن العقل الانساني يحتفظ له بموقع خاص بألوان ممّيزة وبرائحة خاصة وربما بطعم ممّا يستحيل رسمه بالكلمات والصور.
وأجدني أحيانًا أستيقظ وما تزال في عيني بقايا حلم قديم، حلم لا ينفكّ يعاودني عائدًا بي إلى عقود خلت، إلى خمسينيات القرن الماضي، حلم يتجسّد فيه طيف حيّ قديم عشت فيه طفولتي، اذكر منه بيوته الصغيرة المتواضعة شرق عمان، تلك البيوت التي لم يزد عددها عن ثلاثين بيتًا، حي بسيط على مرتفع، يفصل بينه وبين هضبة مقابله وادِ يصل من المحطة إلى ماركا الجنوبيّة وأحياء جبل النصر، وعلى شمال الحيّ كنيسة وبيت كبير لجميل الصالح وقد سمّي الحيّ باسمه، وعلى يمين الحيّ جبل صغير خلف خط سكة الحديد ثم مقبرة قديمة ازدحمت ولم تعد تستقبل زوارًا لها من عالم الأموات.

لقد تغيّر الكثير منذ ذلك العصر البعيد إلى أيامنا، وطوّحت الأيّام بأبناء الحيّ وبعثرتهم في أرجاء المعمورة، لكنّ صورته وصورة رجالاته وأهم الأحداث التي مرّت به ظلّت محفورةً في قلوبنا في أخاديد عميقة استعصت على الزوال والنسيان، ولعلها شكلت وصاغت الكثير من معالم شخصياتنا نحن أبناء الحيّ، وأخص عددًا من الأصدقاء القدامى من الحيّ نفسه حرصنا رغم اختلاف الظروف والمعوقات على التواصل مترابطين بذكريات قديمه ومعرفة ومودّة أثيره تسرّبت إلينا من الآباء وبقيت حيّة نابضة، نجتمع والهوى نفسه والحيّ وذكرياته كما هي، والحديث المعاد لا يفقد لونه ولا طعمه. ولم أعرف حيًّا ضم بين أحنائه ما ضمّه حيّنا الصغير من أطياف متنوّعة من مختلف أنحاء الاردن وفلسطين ومصر وسوريا والمغرب، حتّى لقد ضمّ فيمن ضمهم أسرة انجليزيّة وأسرة ألبانيّة ومع هذا الخليط من الجنسيات والأديان كان الجميع لحمة واحده متجانسة متآلفة، لم يعرف الحيّ جامعيًّا واحدًا بين أبنائه آنذاك ولم يعرف إعلاميًّا، ولا أحسب أحدًا من أبنائه كان يشتري صحيفة، كان أهل الحيّ، وأبناؤه يتعايشون حالة من الانسانيّة الراقية تجسّد أنبل القيم وأرفعها من مروءة وتعاون وصدق وبصورة عفويّة لا تكلف فيها، ولعلّ خجلي من سؤال أحدهم من أين أنت؟ يعود إلى بقايا ما تركه هذا الحيّ في نفسي عدا أمور كثيرة أخرى طرأت علينا في هذه الأيام لا تتقبلها النفوس بينما كانت هي الصواب آنذاك، كنّا بوجه واحد في تلك الأيام بينما تعددت الوجوه اليوم دونما خجل أو حياء، ولا أزعم أنّ حيّنا كان قد هبط من عالم المثل والفضائل فقد شابته أوضارَ وهنات لكنّ الصورة الطاغية كانت فعلًا تمثّل عالمًا من المثل قلّما يتكرّر.
ولعلّي أتنقل فيما تبقّى لي من سطور لأرسم بعض ملامح الحيّ حتى تتكامل الصورة بقدر ما تستطيع الكلمات.

المسجد
أمام بيتنا مباشرة كان مسجد الحيّ الذي لا يتّسع لأكثر من مائة مصل، إمام المسجد مصريّ من صميم الصعيد .. الشيخ قطب، أذكره ماردًا هائلا يلبس جلابيّة مرتبه، أذكره أيضًا عصبي المزاج أحيانًا إلى حد رهيب مع روح فكهة، وكانت تتبع المسجد غرفة صغيرة اتخذها الشيخ بقالة لا تحوي إلا على أقل الضروريات.
امام هذا المسجد اعتاد رجال الحيّ أن يجلسوا ويحتسوا الشاي ما بين المغرب والعشاء، لم يقتصر دور المسجد على الصلاة وإنما كان يؤدي دورًا ترفيهيًا لأطفال الحي، فقد كان الأطفال يقصدونه قبيل العصر يلعبون داخله ما بين الصلوات، والأمهات بدورهن لم يكن يساورهن أدنى قلق لأن الأطفال في أمان بينما يتزاورن شأنهن شأن الرجال.
لم يكن غريبًا في ذلك الوقت أن يلعب في المسجد ويتراكض من هم مسلمون فقط، كنا خليطًا متجانسًا مسلمين ومسيحيين .. وأنجليز نعرف لغة واحدة هي اللعب .. مصارعة.. دحرجة... ركض ثم استراحة أثناء الصلاة، ونسأم أحيانًا فنغادر المسجد لتعابث الرجال خارجه ثم نرتد ثانيه داخل المسجد.
الكنيسة
اعتادت كنيسة الحيّ أن تتلقف أطفال الحيّ بمختلف أجناسهم ودونما تمييز، تتلقفهم قبيل المرحلة الابتدائيّة لتعلّمهم مبادئ القراءة والكتابة، وفي الكنيسة .. في صفوفها المخصصة أدركت لأول مرة أن الرياضيات عدوي اللدود وعرفت المعلمات لأول مرة وان ثمة شيئًا أسمه دراسة وتدريس .
اعتدنا اللعب أيضًا أمام ساحة الكنيسة التي تحيطها أشجار باسقة، وطالما حيرنا الخوري الذي كان يلعب معنا قاذفًا كرة صغيرة إلى عنان السماء ثم – لدهشتنا – يخرجها من كمه.
قد يبدو المنظر منظر الخوري بلباسه الأسود وبلحيته الكثّة وما يعتمره على رأسه فضلًا عن وقاره وتزمّته .. قد يبدو هذا كلّه شيئًا غريبًا أو باعثًا على الرّهبة في نفوس أطفالِ لم يتجاوزوا السادسة من أعمارهم لكنّنا كنّا نتراكض مسرعين كلّما لمحنا الخوري، نسرع نحوه ضاحكين مبتهجين وهو بدوره يقرص آذاننا ويختطف كرة صغيرة كنّا نلعب بها ويتظاهر بإخفائها أو قذفها ونحن نتابعه بدقة واهتمام.
لقد تركت فينا ملاطفة الخوري وسماحته أثرًا عميقًا في نفوسنا حتى اليوم، وأنّ مرأى أي رجل دين مسيحيّ لا يزال يستحضر في أذهاننا صور الطيبة والألفة والطمأنينة.
وهكذا كان يتكامل في حينا الدوران، دور المسجد ودور الكنيسة دونما إعلام أو محاضرات أو كلام فارغ

عمود الحيّ
لقد مضى إلى بارئه مرضيا عنه إن شاء الله، وإذا كان المرء يؤجر ويثاب بشهادة سبعة من جيرانه فقد كان يشهد لهذا الرجل جميع من في الحيّ، ويشهد له بالخير والصلاح رفاقه في معسكره بالجيش، ويشهد له من عمل معهم مؤخرا ولسنوات في البحرين.
أشير إلى هذا الرجل باسمه وأرجو العذر، فهو (أبو عوني) عادل يوسف الطوباسي عمل في سلاح الموسيقى في قواتنا المسلحة وإثر تقاعده ذهب إلى البحرين حيث كان له الفضل في تاسيس هذا الفرع وبنائه هناك..
لم يعرف (أبو عوني) بأي لقب، كنا نعرفه بكنيته وحدها، وأعرف كما اكتشفت فيما بعد أنه كان لا يدع مفدوحًا بدين أو مصابًا إلا وأسرع بجمع التبرعات له سواء في حيه أو معسكره، وحدث أن فقد مبلغ ثلاثمائة وستين دينارًا وهو مبلغ كبيرَ آنئذ فجمع له رفاقه مبلغًا يساعده لكن رفض استلام قرش واحد منه.
كنت وبقيّة الصغار ننتظر هذا الرجل بملابسه العسكريّة وهو يصعد الدرج إلى بيته، نقف أمامه معترضين فيمسك بمعصمي أحدنا بقوّة ويجبره على التصفيق فكانت كفّا الطفل تتواليان بالضرب إما على الوجه أو باطن الكفين ومع كلّ ضربة أو لطمة يغنّي "ذهب الليل" ثمّ " طلع الفجر" و "العصفور صوصو" كانت أغنية قديمة للأطفال حفظناها مع ذكرياتها من الضرب المتواصل ولم تكن هذه المداعبة تمنعنا من ترصده يوميًّا هو وغيره أيضًا، كنا نحظى أحيانًا بورقة أو بقلم لكن هذه المداعبة الخشنة كانت تروقنا أكثر لأنها صادرة عن محبة وعن فائض من الحيويّة والنظرة المتفائلة للحياة.
في أيامنا هذه، أيّام التمدّن والحضارة والعناية بالطّفولة كما يقال، في أيّامنا لا أحسب طفلًا ينتظر عودة الموظفين ليداعبهم، وربما يتباعد الاطفال كما تتباعد القطط وتهرب لأنهم لا يتوقعون تحيّة أو كلمة طيّبة والغالب أنّهم يتلّقون اللوم والتقريع بسبب وبلا سبب.
رجال حينا القديم لم يسمعوا بشيء أسمه "الطفولة" ولم يقرأوا عن الفلسفات والعلوم التي تشرح أساليب التعامل مع الاطفال، ومع ذلك فقد حببوا إلينا الحياة وملأوا المكان بهجة، ولم يكونوا أغنياء حتى يغدقوا علينا، ولكن صفعاتهم وقبضاتهم القويّة كانت تنهال علينا وكأنها تحمل أرطالًا من المحبّة تزيل الغم والحزن، هكذا كانوا يداعبوننا ويتعاملون معنا، وهكذا تركوا أثرا طيّبًا في نفوسنا.
غراميات
بعد ما يزيد عن نصف قرن لا أزال أتذكر ملامح وجهها بالتفاصيل الدقيقه، أما نظراتها ، وإن كنّا لا نصمد أمامها .. فقد كانت كفيلة بأن توقف أحدنا متيبّسًا ولا أحسب أن حارة أخرى قد حظيت بفتاه لها مثل قوامها، كنا صغارًا لا يزيد أكبرنا عن خمسة عشر عامًا أو أقل، وحكمت الأقدار وصغر أعمارنا في حينه بأن نبقى أسرى هذا الجمال من بعيد ولا اكثر من ذلك، لم نكن في سنّ النضوج العاطفيّ، لكنّ أحدنا كان أسبق منا في نضجه العاطفي وتسبب هذا النضج المبكر في رسوبه عامين متتاليين، كان يغادر المدرسة بعد انتهاء الدوام ومن ثم يتناول غداءه في البيت ليهرول بعدها مسرعًا إلى سكة الحديد ليجلس هناك ويراقب فتاة الحيّ التي لم يكن يظهر من ملامحها أو هيئتها ما يكشف عن شخصيتها من هذا البعد، لكنّه كان يترصد ويحلم ويحترق، وكان جلّ ما يجيبني به عندما أخاطبه " أرى وجهها في كل صفحة" فلم يكن غريبًا أن يرسب ما دامت مطالعته لم تتعد وجه فتاتنا.

أذكر فيما بعد أنها تزوجت، وأذكر أننا احتشدنا على الشارع لنشاهد العريس، وقد صدمنا عندما عرفنا أنّه من خارج البلد وكانت صدمتنا أكبر عندما تبيّنا أنّه .. أصلع، أما صديقنا المتيم فقد صعقته المفاجأة وانهار تمامًا وهرب إلى بيت صديق لنا في مخيم المحطة ليعالج آلامه بأكواب الشاي وسجائر اللولو..طريحًا.
في مساء ذلك اليوم بحث عنّي شقيق العاشق وكان موظفًا، ولست أدري لم قصدني أنا بالذات، خرجت أمامه ومن شارع إلى شارع ومن دخلة إلى دخله وصلنا البيت المقصود وأدخلنا والد صديقنا إلى حيث يتجرع العاشق همومه، ومن أذنه سيق العاشق إلى البيت وسط تعنيف وبضع صفعات على الرقبة بينما كنت صامتًا معهما أشاهد نهاية قصّة حب.
ولست أدري حتّى الآن سرّ القلوب التي كنّا نرى بها الجمال، ولا أدري لماذا لا تزال تلك الصور حيّة نابضة في أذهاننا، ولا أصدّق أن مرور نصف قرن قد محت تلك الصور أو أنها ستزول وتندثر، ولم يكن غريبًا علينا فيما بعد أن نصدق قصص الحب العذريّ في المدارس والجامعات ... هذا مع أنني كنت مجرد شاهد من بعيد.
لقد تغيّرت ملامح المحطّة وزال المخيّم وقامت مكانه مواقف عديدة وأسواق متنوّعة، غير أنّي كلّما مررت بها لا أزال أتمثّل بيوتها القديمة البسيطة وأتذكّر قصّة صديقنا العاشق الذي تربطني به الصداقة عينها حتى الآن.
"ماري" الانجليزيّة:
على بعد أمتار من بيتنا كانت تقطن ماري الانجليزيّة وزوجها الشركسي وأبنتاها وأبنها، أذكر أن زوجها توفي فطلب منها كلوب باشا آنذاك الاستعداد للعودة إلى انكلترا لكنها رفضت وبقيت حتى الآن، وكانت حجتها وعذرها في الرفض أنها تعرف جميع سكان الحيّ ويعرفونها ويهمّهم أمرها بينما لا تعرف أحدًا في بلادها.
فقدت ماري المسكينة أبنتها الصغرى "سوسو" ذات الجسم الضئيل والشعر الأسود عندما سقطت من الشارع المرتفع إلى الحارة السفلى وبكت ماري وبكى معها الحيّ كلّه، وبقيت الذكرى المؤلمة وذكراها عندما كانت تنسلّ من بيتها إلى والدتي لتنقيب العدس وهي تقول "والله عدساتك زاكيات يا عمتي".
ولماري قصة طريفة مع أول غسّالة كهربائيّة دخلت الحيّ، فقد أقنعت زوجها الشركسي بشرائها وجلس الزوج ليراقب عمليّة الغسيل فطلبت منه شراء الصابون فما كان منه إلا أن هدد برد الغسالة ما دامت لا تغني عن الصابون، وأسرعت ماري إلى والدتي مستغيثة لتقنع زوجها، وبعد التدخل والإقناع سكت زوجها على مضض.
ماري هذه كانت عنصرًا عربيًّا أصيلًا في الحيّ، عرفت حياتنا وأصبحت حياتنا حياتها، أذكر أن الحيّ كله كان يحبها ويقدرها، وأذكر مرضها ذات مرة وتقاطر النساء لمساعدتها والعنايّة بأطفالها، وأذكر أن ابنها قد ضاع ذات مساء فجند الرجال أنفسهم ليبحثوا عنه حتى خطر ببال أحدهم أنه ربما قد نسي في المسجد الذي كان يلعب فيه الأطفال، وهناك وجدوه وقد تلفع بحصيرة نائمًا فلم ينتبه الشيخ قطب إليه عندما أغلق باب المسجد.
لا سيما:
" لا سيما" وإعراباتها المتنوعة قضيّة نحويّة، تذكرني "لا سيما" كما شرحت مرارًا لطلابي في المدارس والجامعات بقصة قديمة لها دلالتها الرائعة.
أحب الشيخ قطب زيارة أهله في الصعيد، حدث هذا بعيد سنوات من الطفولة وكان ابن (أبو عوني) يدرس في جامعة الازهر، وطلب (أبو عوني) من الشيخ قطب أن يسأل عن ابنه بالهاتف إذا استطاع.
وهل يكتفي الشيخ قطب بالهاتف ؟ لقد ذهب الشيخ إلى القاهرة وسأل عن الجامعة وعن كليّة الآداب وعن مكان المحاضرات وهناك أقتحم المحاضرة ليسأل الدكتور عن ابن الحيّ ويوصيه به أمام زملائه، وقد علق الطالب فيما بعد على ما حدث قائلًا: صدّقوني لقد وقف شعر رأسي عندما رأيت الشيخ قطب أمامي في المحاضرة وكأنّ أهل الحيّ كلّهم قد حضروا.
لقد احترم الدكتور الفاضل شيخ الحيّ وسأله، وأفاده الشيخ قطب عن أهل الحيّ وأنهم زوّجوه مرّتين وأنّ هذا الطالب بمثابة أبن له وأعجب الدكتور بما سمع ودعا الشيخ للانتظار بالجلوس داخل القاعه ريثما ينهي محاضرته عن (لا سيما).
وفيما بعد وبعد عودة الطالب كان الشيخ يمازحه أحيانًا ويسأله: "أزاي لا سيما" وأعرف أنّ الشيخ كان غنيًّا عن زيارة الطالب والاستفسار عنه، وأن والد الطالب عندما أعطى رقم الهاتف للشيخ كان يقصد مجرد الاستفسار والاستئناس، لكن ذلك كلّه كان شيئًا مخالفًا لعرف الحيّ وعادات أهل الحيّ إذ لابد من الاطمئنان شخصيًّا.
تعاون
في أيامنا وقد قطعنا شوطًا بل شوطًا في المدنيّة والحضارة ونلنا تعليمًا راقيًا وثقافة واسعة تقطّعت الأواصر والعلاقات وتباعد الجميع حتّى الأقارب، وغدت المصلحة الماديّة فوق كل اعتبار، وأصبح الاستفسار عن الجار أمرًا غريبًا وربما مستهجنًا وتدخلًا فيما لا يجوز.
أما في حيّ جميل الصّالح، حيّنا العتيد فقد كان الناس بحالة طبيعيّة، فثمّة جار يتقن أعمال الحدادة وآخر أعمال النجارة، وآخر يصلح الأدوات، هؤلاء جميعًا كانوا يتعاونون بكل سرور وأريحيّة، يتبادلون الخبرة ويقدمونها طوعًا.
حتى المريض في حينا كان يجد الملاذ والمساعدة، وقد تمرّض احداهن وتقعد عامًا كاملًا فتلقى من أنواع المساعدة والعون من جاراتها ما يغنيها عن أهلها البعيدين.
ويتزوّج أحدهم (طلال) من الكرك ويحضر عروسته فتعلّمها جاراتها مبادئ الطبخ ويسهلن عليها غربتها فتسلو وتصبح فردًا من الحيّ لا تعاني غربة أو قلقًا.
أذكر فيما أذكر أنّ أربعة من رجال الحيّ تعاونوا على إصلاح "راديو" عنيد لوالدي بشتّى الطرق، ولا أذكر إن كان هذا الراديو قد نطق أو ظل على عناده، يكفي أنني أتذكّر شكله الغريب فقد كان أشبه بحقيبة أو صندوق صغير، وعرفت أنّه كان هديّه من جندي إنجليزي ولا أعرف كيف وصلنا ..قد يصلح لو بقى ليكون تحفة نادرة.
قطط...وثعابين...وفئران
لم يكن الشيخ قطب تاجرًا بالفطرة، كان عصبيّ المزاج ولا يحتمل الفصال والنقاش في البيع والشراء، إمّا أن تشتري أو تذهب، ولم تكن بضاعته في دكانه الصغير تزيد عن عشرة أنواع من الضروريات من بيض ولبن وملح وصابون وما شابه، ولا أعرف لماذا كان الشيخ يضع البيض على سطح دكانه الذي يتصل به سور بعدة أمتار، سور لا يتعدى سمكه بضعة سنتمترات، ويبدو أن الشيخ لاحظ تناقص أعداد البيض وشاور رجال الحيّ حول الموضوع أثناء جلساتهم، بقي اللغز قائمًا وبقي الشيخ على عادته في حفظ البيض على السطح حتى يكتشف السر، وذات يوم بعيد صلاة العصر طرق الشيخ باب بيتنا ليطلب من والدي مشاهدة أعجب منظر وتسرب الخبر وجاء آخرون، كان المنظر عجيبًا يستحق أن يصوّر، فقد كان ثمة فأران يقومان جهارًا نهارًا بسرقة البيض ونقله من فوق السور بسرعة قياسيّة ودون استعانة بوسيلة نقل، كان أحدهما ينبطح على ظهره بينما يقوم الثاني بعد ذلك بدحرجة البيضة إلى بطنه ليمسكها بقوة بقوائمه الأربعة ثم يستدير الثاني فيمسك ذنب زميله بأسنانه ويسحبه بسرعة من فوق السور، يومها سامح الشيخ الفأرين قائلًا "سماح يا أبالسة"، لكنّه لم يعد بعدها لحفظ البيض على سطح دكانه .
أما القطط .. فلعلّي لم أر منذ تلك الايّام قططًا توازي في شراستها قطط ذلك الحيّ، وأذكر أنني غافلت قطّة منها أثناء عودتي من السوق ومعي كيس شاي، غافلت هذا القط الذي كان واقفًا على طرف الشارع المطل على الحارة السفلى ودفعته بقدمي ويبدو أن دفعتي لم تكن قويّة فارتد عليّ ممزقًا كيس الشاي ومنطلقًا هاربا، وكانت مشكلتي أن والدي كان يراقب ما يحدث من سور المنزل وسألني أين بقيّة الشاي؟ أجبته أوقعته القطه، ولا أذكر أنني نلت عقابًا على ما ارتكبت ويظهر أنّ والدي أكتفى بما أحدثته قفزة القطة من رعب في نفسي.
في حينها كنا نشتري الشاي (فرط) أي محلولًا يلف في أوراق وكان هذا سر تمزق الورقة وتناثر الشاي.
ومن حكايات القطط وما وصلت إليه من جراءة أن أحدها أختطف ديكًا من أمام أصحابه وانطلق كالبرق، ففي صباح يوم جمعة خرج بعض أهل الحيّ ليذبحوا ديكًا كبيرًا، وذبح الديك وبدأ يتقافز من مكان لمكان مضرجًا بدمائه بينما نحن الصغار نستمتع بهذا المنظر، ونسي الجميع أنّ ثمة قطًا كبيرًا كان يترصّد ويراقب معنا ما يحدث، وفجأة قفز هذا القط واختطف الديك بسرعة هائلة أذهلت الجميع وكأنه يقول: هذا الديك من نصيبي وليس من نصيبكم، لحق الشباب بالقطّ الشجاع لكنّه اختفى وعاد الجميع بالحسرة يتوعدون القط اللعين لو شاهدوه ثانيّة.
وحول الثعابين .. يبدو أننا وفي بيتنا خاصّة كنّا محظوظين بها إذ كان وراء بيتنا مباشرة فراغ عميق كان وكرًا للثعابين، واذكر في مناسبتين أنّ والدتي كانت تغلق علينا الأبواب لتستنجد بالمارّة من العسكر ليقتلوا ثعبانًا على ظهر المطبخ، واذكر أنّ أحدهم التقط الثعبان بيده ومضى به مسرورًا بينما ثعبان آخر قتله جار لنا كان قد جاوز السبعين بعد أن تخوّف ابنه من الإقدام عليه، امتد هذا الثعبان من راس سلم طويل إلى الأرض فما كان من جارنا الشهم إلا أن أطبق على عنقه بعتلة حديديّة حتى خمدت حركته.
مثل هذه الأمور كانت تحدث أثناء غياب رجال الحيّ عن بيوتهم في العمل، ولعل مرأى الثعابين كان مألوفًا إذ كنا أحيانًا نلعب أسفل (الكامب)[1] ونتراكض بين الأعشاب الطويلة والثعابين تنساب تحت أقدامنا فنكتفي بالقفز عنها دون أن يشغلنا الخوف منها عن اللعب، وقد عرفت مؤخّرًا في حديث ذكريات أن بنات الحيّ أيضًا كنّ يلعبن ويتراكضن في الكامب وهن يرين الثعابين ولا يبالين بها.
لا نهاية
لكل قصّة نهاية، ولكلّ حيّ نهاية، هذا ما اعتدنا أن نقوله في القصص والحكايات، ورجال الحيّ انتقلوا إلى بارئهم ولا أقول أنهم "ماتوا". لم يمت هؤلاء وقد تركوا وراءهم أبناء ومعارف وأصدقاء يدعون لهم ويستمطرون رحمة الله عليهم.
لم يمت هؤلاء وقد خلفوا ذريّة وأطفالًا تشربوا من أخلاقهم ألوان المروءة والشرف والرجولة.
ولم يمت هؤلاء لأنهم كانوا "أحياء" بترفّعهم عن الصغائر والتوافه، ولأنهم غادروا هذه الدنيا بجباه مرفوعة وكرامة تطاول عنان السماء.
بقي هؤلاء في قلوبنا لأنهم بسلوكياتهم الطيبة وبفطرتهم الانسانيّة النقيّة علّمونا الوحدة الوطنيّة قبل أن تلوكها الألسنة وتبتذلها الأقلام.
علّمونا الرجولة وكفاهم .. علّمونا المرؤة وكفاهم.. علّمونا الأخوّة والمحبّة وكفاهم.
أختم سيرة هذا المكان بسطور شعريّة لعيسى بطارسه، وهو شاعر أردني عاش الغربة ويبدو أنه تجرع مرارتها فحن إلى حواكير عمان القديمة.
علمتني – يا صديق العمر – أوجاع التجارب.
والمطارات وأبعاد المحيطات وفوضى المطارات
ووجوه قد غشاها أرق الترحال حولي
وعيون شحبت فيها كما في محجري النظرات
علمتني – يا صديق العمر – أوجاعي الجديدة
أن كل الكون.. شرقًا كنت أم غربًا شمالًا أم جنوبًا
أينما قادتك في الدنيا الدروب
تنتهي إذ تبدأ إلى الدرب التي منها أتيت