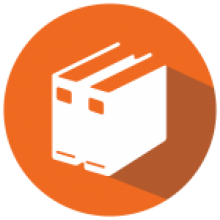- الرئيسية
- مديرية التراث
- نبذه عن المديرية
المزيدأولاً: نشأة المديرية تم تأسيس مديرية التراث في نهاية عام 2010 وذلك حرصاً من وزارة الثقافة على رعاية وصون التراث الثقافي غير المادي في المملكة الاردنية الهاشمية. «التراث الثقافي غير المادي » الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية...
- أهداف مديرية التراث
- اقسام المديرية
المزيدأقسام مديرية التراث: 1- قسم البرامج التراثية : من أبرز مهامه تنظيم وتنفيذ ومتابعة المشاريع والبرامج والأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي ضمن خطة المديرية والجهات ذات العلاقة، ومتابعة الاتفاقيات التي تعقدها المملكة مع المنظمات والهيئات الدولية لغايات تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن نطاقها. 2...
- الاصدارات المزيد
- التعليمات والاتفاقيات المزيد
- نبذه عن المديرية
المزيد
- المشاريع
- مشروع المكنز الوطني
المزيداختصاصات لجنة ذاكرة العالم الأردنية الاسم: Jordanian Memory of the World committee اللجنة الأردنية لذاكرة العالم الهيكل: تتألف لجنة ذاكرة العالم الأردنية من لجنة رفيعة المستوى و 4 لجان فرعية متخصصة في مختلف جوانب اللجنة. الوظيفة: ستضطلع لجنة ذاكرة العالم في الأردن بمسؤولية...
- المشروع الوطني لحصر التراث
المزيدنبذة عن المشروع يهدف هذا المشروع إلى حصر التراث الثقافي غير المادي في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتزامن. كما يهدف إلى إشراك المجتمع المحلي في الجرد، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، وتحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي المهدّدة بالانقراض، ورفع الوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي حتى...
- مشروع تفريغ و أرشفة أشرطة الكاسيت المسجلة في أواسط السبعينيات
المزيدمشروع إعادة تأهيل المادة الصوتية المسجّلة في السبعينيات من القرن الماضي. (الذاكرة المسجّلة في أشرطة الكاسيت التقليدية) للحفاظ على الموروث الأردني الثقافي، والكنز الذي قامت بتسجيله نخبة من الباحثين في التراث في أواسط السبعينيات، وفي مناطق مختلفة من المملكة، ارتأت مديرية التراث أن يصار إلى البحث عن...
- برنامج ذاكرة العالم
المزيداختصاصات لجنة ذاكرة العالم الأردنية الاسم: Jordanian Memory of the World committee اللجنة الأردنية لذاكرة العالم الهيكل: تتألف لجنة ذاكرة العالم الأردنية من لجنة رفيعة المستوى و 4 لجان فرعية متخصصة في مختلف جوانب اللجنة. الوظيفة: ستضطلع لجنة ذاكرة العالم في الأردن بمسؤولية...
- مشاريع مدن الثقافة
المزيد
المشاريع
تم تخصيص جزء من مخصصات مدن الثقافة والالوية في الاعوام السابقة لدعم مشاريع تراثية تُعنى في الحفاظ على الموروث الشعبي الاردني وتسويق المنتج التراثي ودعم الافراد والجمعيات والفرق التراثية. حيث قامت مديرية التراث بالتنسيب بدعم المشاريع التي تحقق روية ورسالة المديرية وتسلط الضوء على المنتج التراثي... - مهرجان التنوع الثقافي
المزيد
المشاريع
يأتي ضمن احتفالات العالم باليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي يصادف 16/5 من كل عام، ويهدف هذا المهرجان إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي الاردني وتعزيز الترابط بين كافة أفراد المجتمع الأردني وإبراز نسيج الحضارة الأردنية وجماليات التنوع الثقافي في الأردن والتعريف بالهوية الثقافية المتميزة لدى الأردن... - ترشيح العناصر على قوائم التراث الثقافي غير المادي
المزيد
المشاريع
بعد ان يتم حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي في المملكة وادراجها على قوائم الحصر لدى مديرية التراث، تقوم المديرية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بترشيح عناصر مختارة على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي. إن ترشيح عنصر واحد على قوائم التراث سواء كان ملف وطني أو مشترك يستغرق عامين ويتطلب تحضير... - العناصر الاردنية المدرجة على قوائم اليونسكو
المزيد
المشاريع
تم ترشيح ملف (العادات والتقاليد والممارسات المتعلقة برقصة السامر) في الاردن على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وستعلن نتائج الترشيح خلال شهر تشرين الثاني من العام 2018. ترشيح ملف النخلة والعادات والطقوس المرتبطة بها: تراثاً عربياً مشتركاً على القائمة التمثيلية للتراث...
- مشروع المكنز الوطني
المزيد
- المركز الإعلامي
- قواعد البيانات
- قاعدة بيانات المكنز الوطني
المزيد

- قوائم الحصر الوطني
المزيد

- قاعدة بيانات الحرفيين
المزيد
قاعدة بيانات الحرفيين
- قاعدة بيانات المكنز الوطني
المزيد

بين عمان والسلط.. شيء من ذاكرة المكان *د.هدى فاخوري
على حياتي وإذا بي أسكن في بيت في منطقة المحطّة، حيّ من أحياء عمّان، كان بيتًا متواضعًا، يتكوّن من غرفتين مفتوحتين على حوش اسمنتي، ننزل درجتين فندخل إلى المنطقة الغربيّة حيث يقع المطبخ والمنافع، إذا سرنا شرقًا كنّا نسير في البستان المزروع بالأشجار المثمرة، أتذكّر منها شجرة الخوخ التي لم نعرف طعم ثمارها الناضجة أبدًا!
كنا نلعب وأولاد الجيران، ونتلذّذ بقطف الثمار العجرة (غير الناضجة) من أشجار بيتنا وبيوت الجيران، ولكنّ دالية العنب كانت تصمد أمام شقاوتنا، إذ كان الوالد يضطرّ إلى " تكييسها" بأكياس ورقية لنتذوّق طعم العنب الأبيض الذي تتدلّى قطوفه فوق رؤوسنا على شكل قواوير صغيرة شفافة ،ونحن نخرج وندخل من الغرفة الشرقيّة إلى الحوش الترابيّ.
"ثمر الدار يطّول الأعمار" هكذا كانت أمي تردّد كلّما تقطف قطفًا من العنب وتقدّمه لإحدى جاراتها.
أذكر أيضًا (تلوم) البصل الأخضر الذي كنّا نزرع (قناراته) الصّغيرة في جزء صغير من الأرض لنكتشف بعد مدّة بسيطة بزوغ الأوراق الخضراء، ونظلّ نرقب نموّها إلى أن تطلب أمي من أحدنا أن يقطع بعض أوراق البصل لتضيفها إلى السلطة، أو تحزّمها على قطعة من خبز الشراك وتأكله بتلذّذ.
أمّا شجيرات العُصفر، فلها حكاية شيّقة، حيث كنّا نزرع بذرة العصفر البيضاء المصقولة على شكل قطعة الألماس الصغيرة، بعد مرور مدّة كافية، تبدأ السيقان البيضاء النحيفة المورقة بأوراق يميل لونها إلى الأصفر والأبيض، بإنتاج كؤوس مغلقة، ثمّ تبدأ هذه الكؤوس بالتفتّح لتظهر أوراق العصفر الصفراء البرتقاليّة، ثم تتفتّح الكأس كاملة، فيأخذ أحدنا صحنًا ليجمع أوراق العُصفر.
تبتسم الوالدة وأشعر بسعادتها، فقد كانت تعشق العصفر وتضيفه للرز فيصبح لونه كالذهب، وتضيفه للجميد المسيّل أيضًا معبّرة على أهميته في طعامها.
أما" الحشائش" كما كنا نقول عنها، فقد كنّا نزرع الرّشاد والفجل والخسّ والنعناع والبقدونس الذي نتفنّن في صنع " التبّولة" منه لتتذوقها بنات الجيران معنا. وغالبا ما يدق جرس الباب ظهرا ليطلب أحد الأولاد من الجيران " كمشة بقدونس" لإضافتها للسلطة.
كان سور البيت في أوائل الخمسينات من القرن الماضي عبارة عن " سنسلة " من الحجارة الصغيرة، مرتبة بطريقة شبه هندسية، وغالبا ما كنّا نرى رؤوس الحراذين وغيرها من الزواحف، تطلّ من بين الحجارة فترعبنا، إلا أنّ الاولاد كانوا يحاولون الإمساك بها.
باب البيت لوح خشبي دون (سقّاطة)، يفتحه من يشاء ليدخل إلى البيت آمنا.
حقول القمح تمتدّ على مدى النظر من الجهة الغربية من البيت، ندخل إليها أحيانا في غفلة من المزارعين، نبحث عن نبتة كنا نسميها "عِلت"، أظن أنها (الهندبة)، نقطفها ونأكلها نيئة، ولن أنسى أبدًا دخولنا ذات مرة، وإذا بالمزارع يصيح بنا طالبًا منا الخروج، كنّا أولادًا وبناتًا من الجيران، وكنت ألبس قُبقابًا خشبيًّا، ركضنا خائفين للخروج من حقول القمح، وعلِق القُبقاب في الطّين وضاع إلى غير رجعة، ولا أزال أتذكر تلك الحادثة بكثير من الحنين.
في فصل الشتاء كنا نسير في الوحل، لنصل إلى مدرسة عمّان الابتدائيّة مشيًا على الأقدام، وكنّا نحاول القفز فوق الحجارة حتى لا تنغرز الأحذية في الطين، ونبهتني إحدى بنات الجيران أن والدها قال لها: لا تقفزي فوق الحجارة، بل سيري في الطين كي لا تهترئ النعال، فوجئت بما قالت، ولكنّي أذكر أننا كنّا ندق حذوتين في نعال الحذاء واحدة من جهة الكعب، والأخرى في الجهة الأماميّة لنحمي النعال من الاهتراء السّريع، وعندما نمشي على البلاط في المدرسة، كنا نسمع "تك..تك"، وكان هذا الصوت يزعج المعلمات.
لم أترك المحطة إلا بعد أن أصبحت في الرابعة عشرة من عمري. كانت لنا خالتان ، إحداهما معلّمة والثانية ممرّضة، وكنّا ننتظر زياراتهما بفارغ الصبر، حيث تحضران معهما الحلوى والهدايا، وكان هذا نادرًا في ذلك الزمن.
دعتني خالتي للذهاب معهما إلى السّلط، إلى بيت جدّي. لم أكن قد زرت السلط بعد مع أنني من مواليدها، ركبنا الباص من المحطّة إلى عمان، ومشينا إلى شارع السلط حيث ركبنا باصًا آخر لنصل إلى السلط بعد ساعة تقريبًا، تجربة فريدة، أنظر من شباك الباص وأتمعّن في الطريق الضيّقة المتعرّجة والحقول والأراضي ذات التربة الحمراء، والمناطق المشجّرة، وأتخيّل كيف ستكون مدينتي التي لم أكن أعرفها إلا من خلال صورة في كتاب القراءة في الصف الرابع الابتدائي، كانت صورة المدينة مرتبطة بذلك المشهد الغريب وهو شخص يركب حمارًا في الشارع الرئيسي في المدينة..!
عدما وصلنا إلى مشارف المدينة، انفتح أمامي مشهد لا أنساه، رأيت المدينة معلقة على هضبة، شبابيكها ذات أقواس، ولون الحجر يميل إلى الأصفر. تعلق قلبي بالمشهد الأسطوري، وتساءلت.. كيف تكون مدينتي: بهذا الجمال ولا أعرفها.
نزلنا من الباص في الكراج، وسرنا نحمل أغراضنا إلى بيت جدي، يسكن جدّي في منطقة تدعى" الحارة"، اجتزنا طريقًا طويلًا شبه معبّد يمرّ بين مبنيين، أحدهما جامع بمئذنة شامخة، والآخر كنيسة للطائفة الإنجيليّة. سرنا طلوعًا بين أشجار التين والزيتون والرّمان إلى أن وصلنا البيت. أحسست لحظتئذ أنّ بيت جدّي قلعة، كان جدي يملك بيتّا فلاحيًّا قديمًا، يتكوّن من طبقات ثلاث، دلفنا إلى "قاع البيت"، حيث توجد أدوات المطبخ من الطناجر الكبيرة والبريموس والمنقل، وجرار الماء المصنوعة من الفخار، مرفوعة على كراسي خشبية خاصّة لتقعد عليها الجرار المغلفة بالخيش لحمايتها. لاحظت وجود (كيلة) نحاسيّة مربوطة على أذن الجرة يغرفون الماء بواسطتها ركضت لأشرب الماء من إحدى الجرار، غرفت الماء بالكيلة وإذا بخالتي تصيح من بعيد.. لا تشربي من هذا الماء فهو مخصص للغسيل، وعرفت أنّهم يضيفون إلية السّكن (الرماد) ليصبح الماء سهلًا من أجل غسل الملابس بسهولة.
أعطتني خالتي ماءً بكوب زجاجيّة من "شربات" فخارية مرصوصة في مكان خاص، وحولها قطعٌ من الخيش المبلّل بالماء لتظل باردة، غالبًا ما يبلّلها الماء الذي يرشح من "الشربات" نفسها.
صعدت بضعة درجات لأصل إلى "المصطبة"، وهي غرفة المعيشة عمليًّا، أرضها اسمنتيّة ناعمة، وجوانبها مفروشة ببسط حمراء مخطّطة بألوان زاهية، وعلى جوانبها مساند موضوعة للاتكاء يرتاح الذين يجلسون عليها، وفي صدر المصطبة يوجد "الوهد" وهو المكان الذي يضعون فيه الفرشات واللحف والمخدات، يفرشونها بالليل، ويطوونها بالنهار، وهي مرتّبة بطريقة هندسية، توضع الفرشات مطوية على ثلاث طبقات بعضها فوق بعض. في جانب من الوهد، وتطوى اللحف أيضًا لتصبح شبه مربّعة على الجانب الآخر، ثم توضع المخدات فوقهما. يمتدّ سلك معدنيّ من طرف الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، وتدكك البرداية بحلقات معدنيّة لتغطي الوهد عن الجالسين في المصطبة.
قلت لخالتي هذا عمل يوميّ شاق، فقالت: نعم علينا ترتيب يوميًّا على هذه الصورة، وهيلانة "أمك" كانت أشطرنا في ترتيبه بطريقة هندسية، وقد أحضرت لها خالتك "مريم" ذات مرة "ميزان " الماء ليكون الوهد منظما بطريقتها لأنّه لن يعجبها ترتيب أيّ واحدة من الشقيقات، وكانت هذه طرفة نتندر بها في سهراتنا.
قالت لي خالتي: هل رأيت" الكواير "؟ انها أهمّ ما في هذا البيت، انها أمكنة لتخزين القمح والطّحين والحبوب الأخرى مثل العدس والحمص وغيرها من مؤونة الشتاء. الكوارة موجودة في الجهة الشرقية من المصطبة كجزء من الحائط، وقد اكتشفت أن الحائط عريض، وقد يكون عرضه مترًا؛ لهذا يصلح لخزن المؤونة، الكوارة لها فتحتان واحدة علويّة واسعة لوضع المحصول من خلالها، الثانية توجد في أسفل الكوارة، وهي فتحة صغيرة مغلقة بقطعة قماش مكورة، وعندما ترفع قطعة القماش ينزل الطحين أو الحبوب في الجونة المخصصة، وهي مصنوعة من القش، وغالبًا ما تصنعها الفتيات من القَصَل (سيقان القمح) بعد جفافها. كما يصنعن أيضا أطباق القش التي تستخدم كثيرّا لوضع الطعام عليها مثلًا.
قالت خالتي: كواير دار عمي أكبر من كوايرنا. سألتها لماذا؟ أجابتني: يمكن محصولهم أكبر من محصولنا. قلت لخالتي: هل نزورهم؟ أجابت طبعا ولكن بعد الغداء.
صعدت بضع درجات أخرى ورأيت "السدّة" وهي المكان المخصّص لاستقبال الضيوف والسهر. والسدّة هي سطح لغرفتين ملحقتين بقاع الدار، لهما بابان تفتحان خارج الدار. وكان يسكنهما في معظم الأحيان الطّلاب اللذين يأتون من المدن الأردنية الأخرى الذين يدرسون في مدرسة السلط الثانوية ، وهي المدرسة الثانوية الوحيدة الموجودة في الأردن في بدايات القرن الماضي.
وقد سكن عندنا عدد كبير من الطّلاب الذين أصبحوا فيما بعد من المسؤولين في الدولة. كنا نعاملهم كأبنائنا، وكأنهم من أهل الدار، وعندما يعودون من الإجازة الصيفيّة، كانت أمهاتهم ترسل معهم بعض ما تجود به الأرض من المؤونة والفواكه المجففة وغيرها من المأكولات الشهيّة.
السدّة مرتّبة ومفروشة ببسط جميلة، جديدة ونظيفة. بسط وجواعد ومساند، يتوسّطها منقل الفحم، ودلال القهوة السادة المستريحة في النار باستمرار، وبكرج القهوة وفناجين القهوة السادة مرتّبة تحسبًا لحضور الضيوف من الأهل أو الجيران في أيّ لحظة.
السطح المطل على المشهد الخارجي مسوّر بتنك السمنة الفارغة المزروعة بنباتات بلدية مزهرة، وكان يحلو لجدتي أن تجلس على سطح الغرفتين في الصيف حيث الهواء المنعش الآتي من الجهة الغربيّة، "زي" المطلة على فلسطين حيث كانوا يتاجرون مع مدن الساحل الفلسطيني ومن المحاصيل المهمّة في هذه التجارة آنذاك العنب والتين.
أحببت أن أرى مسقط رأسي في بيت جدّي لأبي، حيث سكنت أمّي بعد أن تجولت مع والدي في بداية حياتها بعد الزواج من معان إلى إربد إلى عجلون إلى عمان ثم إلى السلط، حيث ولدت بعد خمسة أطفال في بيت جدي لأبي. وهو قريب من بيت جدي لأمي، أي في الحارة.
أنجبت أمّي أختي التي تكبرني مباشرة بالكروم في زي، حيث كانوا يصيفون" يعزّبون" كل عام، في شهر أيلول، و كانوا يتندّرون ويقولون: إنها كانت تشرب الحليب مباشرة من ضرع البقرة.
حدثتني خالتي عن حادثة تتعلق بقصّة عن ظروف ولادتي، وهي قصّة ظلّوا يردّدونها أمامي لسنوات طويلة، رغبت إحدى بنات عمّ والدي أن تخلق جوًا من الفكاهة في العائلة، فقالت لأمي وزوجة عمي: من تلد بنتا "سأفلّت سرّها"، بمعنى أن" تتركها لتموت"، وعندما وُلدت، وأنجبت زوجة عمي ولدًا، قالت أمّي لمريم: تفضّلي " افلتي سرها"، خافت مريم وقالت لأمّي: وانا مالي "ليش هو أنا اللي بدّي أتعب بتربيتها". فقالت أمي قولتها المشهورة " هذه البنت السمراء التي لا تعجبكم، سأعلّمها وأربّيها أحسن تربية، وستصبح أحسن من أولادكم". وكان هذا التّحدي يتكرر أمامي كثيرًا فيما بعد.
زرنا فيما بعد بيت خالتي الكبيرة ولاحظت كواير بيتهم الكبيرة، فسألت خالتي، ما هي القصّة التي ستروينها لي عن " كواير دار خالتي"؟ فقالت: صار فيه "دم في العيلة"، يعني أولاد العم صاروا أعداء، أحدهم قتل ابن عمه على خلفية أحقيته في زراعة الأرض لهذا العام، اضطرّت خالتك لإخفاء القاتل في الكوارة إلى أن" يبرد الدم "، ويحلّوا القضية عشائريا. فتحت عينيّ دهشة وسألت: كيف يسكن رجل في الكوارة، ولا يلاحظه أهل الدار؟ أجابت خالتي: عندما دخل في الكوارة لم تلاحظة خالتك فقد كان الرجال مشغولين في حادثة القتل، وفيما بعد همس لها عندما أدرك أنّها وحدها في البيت، وطلب حمايتها، وأكّد لها أنّه لم يقصد قتل ابن عمه، بل دخلت الشبرية في بطنه وهما يتعاركان على حقّهما في زراعة الأرض.
ارتبكت خالتك وقالت له: يجب أن لا أراك أبدًا، فاذا سألوني عنك سأجيبهم: " عيوني ما نظرنه" أي أنها لم تره، لتكون صادقة في جوابها. اختبأ القاتل في" الكوارة" إلى أن رتّب جدّك والأعمام القضيّة عشائريًّا، تمهيدًا لتسليمه للحكومة ليأخذ الحقّ العام مجراه، بعد أنّ تم الصلح في العائلة.
كانت قصة شبه خياليّة في نظري، ولولا أنّني رأيت المكان بنفسي لاتهمت خالتي أنها تؤلّف القصص.
مكثت في دار جدّي أسبوعًا أتمتّع بالطّعام والأجواء الريفيّة وأستمع لحكايات خالتي، الراوية المبدعة، وقد الهمتني حكاياتها فيما بعد لكتابة كتابي " حكايات العمة عربية" لليافعين.
جدتي "حبوس" صغيرة الحجم دقيقة الملامح، تلبس الملابس التقليديّة لأهل البلقاء، "الخلقة والحطة"، وهي ملابس مميّزة لمنطقتنا، الخلقة طويلة جدًا، وعندما تلبس جدتي خلقتها تطويها عند الخصر بحزام خاص، فتصبح ثلاث طبقات، ويبدو أنّ هذا مقصود حتّى لا تظهر تفاصيل جسد الأنثى، فنحن نعيش في منطقة محافظة جدًّا، وهذه الملابس تعكس السلوك الاجتماعي للمجتمع المحافظ.
وأمّا الحطّة فهي قطعة كبيرة مربّعة من القماش المقصّب بخيوط ذهبيّة أو فضيّة، سوداء أو حمراء، وتُطوى بطريقة معينة، تضعها المرأة على رأسها فتبدو كالتّاج الذي يحيط بالرأس. وتتباهى النساء بجودة القماش، فهناك الحرير والحبر والدوبيت وغيرها من أنواع الأقمشة المستوردة من سوريا غالبًا.
تتفنن النّساء في تطريز ملابسهن، ويكون الاهتمام بالجزء الخلفيّ من الثوب الذي يجر على الأرض، وهذا يلفت نظر الرّجال الذين لا ينظرون إلى وجه المرأة تعفّفا، ويعرفون مكانة المرأة الاجتماعية من طبيعة التطريز على ذيل ملابسها.
روت لي خالتي أيضًا كيف كانت تذهب الفتيات زرافات ووحدانًا لملء جرار الماء من العين القريبة، تحمل الفتيات جرار الماء على رؤوسهن وهنّ عائدات، ويقف الشباب من بعيد ينظرون لأسراب الفتيات، ولكلّ شاب "هوية"، أي حبيبة لا يستطيع القرب منها أو محادثتها خصوصًا إذا لم تكن من بنات العم القريبات. سبقت مرّة هيلانة سرب الفتيات، فتقدّم شاب جريء ورمى العباءة تحت قدميها للتعبير عن إعجابه بها، لم تعره الفتاة اهتمامًا ومشت بعيدًا عن العباءة، ولكن القصّة أصبحت حديث السهر بين فتيات الحي.
ذهبت مع خالتي إلى بيت جدي لأبي لأرى المكان الذي وُلد فيه، نظرت من الشباك المطل على الحوش، فقد كان محدّدا، أي محميّ بشبك من الحديد، وتذكّرت حادثة كانت ترويها أمّي عن أحد أخوتي الذي وقع من الشباك، كان شقيقي عنيدًا، وظلّت أمّي تعلّق دائمًا، أنّ سقوطه من عل قد يكون أثّر عليه، متندّره من قدرته على معاندتها. دار جدّي لأبي تشبه تقريبًا دار جدي لأمّي، يسكن فيها أبناء وبنات عمّي وأمهم. ولهذه الدار قصّة محزنة أثّرت في علاقتنا بأعمامي لفترة طويلة من الزمن.
وقفت في الحوش فلاحظت وجود قبرين في المنطقة المنخفضة إلى جانب الطريق، عجبت لوجودهما، فهما أول قبرين أراهما في حياتي، ولم أعرف أبدًا سرّ وجودهما في فناء الدار. عندما شاركت فيما بعد في الانتخابات النيابية العام 1989، زرت كثيرًا من بيوت السلط القديمة، والحديثة، وكنت أتطلع بحنين جارف للسلالم والأدراج والسقوف العالية، كما كنت أنظر إلى أشجار التّين والرّمان وكروم الدوالي بحبّ ولهفة، وكانت نباتات الزّينة تشكّل لي شوقًا لأيّام خلت عندما كانت النباتات مثل الغريب، البيجونيا، الريحان، نبتة الهوا، والخبيزة بألوانها البديعة، ونبات الشمعة الموجودة بكثرة في غرف الضّيوف في بيوت السلط، وكذلك نبتة السّجادة بأشكالها وألوانها المختلفة.
ولن أنسى ذلك البيت الذي صعدنا إليه درجًا مزروعة على جوانبة نباتات الغريب بجميع ألوانها، وأشجار الليمون المزروعة في البستان، ويتدلّى الليمون الأصفر على أغصانها بشكل بديع.
وقد أكرمتنا صاحبة البيت، وشربنا عصير الليمون الطازج المثلج ونحن نقوم بجولتنا الانتخابيّة، لنحصل على أصوات النساء اللواتي تشجّعن كثيرًا في هذه الانتخابات ؟ لأنها المرّة الأولى التي يحقّ للنّساء الترشّح كنائبات في البرلمان الأردني.
كانت تجربة رائعة، أتطلع اليها بحنين ومحبة. وقد تعلمت كثيرًا من تجربتي، وأحببت مدينتي أكثر، فهي لم تخذلني أبدًا، على الرغم من أنّني لم أوفّق في الحصول على مقعد في البرلمان، لكنّني وفّقت بالتعرّف إلى كثيرين كانت التعرّف إليهم كالتعرّف إلى نفسي، ومنهم مدينتي، السّلط.
* طبيبة، وكاتبة أردنية
في حالة النقل أو الإقتباس يرجى الإحالة الى المصدر: مجلة الفنون الشعبية ،العدد 17 لسنة 2014